دفتر أوجاع مصر كتاب جديد للدكتور عمار على حسن صادر عن دار الشروق
عمرو محمد
“نحن مجتمع في خطر” بهذه الجملة الصادمة للمتلقي يفتتح عمار علي حسن كتابه “أبواب الأذى” الصادر عن دار الشروق، وتعيدنا هذه الجملة إلى تأمل عنوان الكتاب وهامشه المؤشر: “دفتر أوجاع مصر” كافيان ليعرف القارئ ما سيجده داخل الكتاب، لكن المقدمة تأخذ أفق توقعنا إلى ما هو أبعد؛ فالمؤلف يختار عنوانًا لأهم تقرير إصلاحي في الولايات المتحدة: “أمة في خطر” ورغم تركيز التقرير على إصلاح التعليم، ورغم أن صاحب التعبير هو الرئيس الأمريكي “رونالد ريجان” فإن الجامع هنا، هو الخطر، والمسؤولية الأخلاقية التي حذت ريجان وعمار إلى هذا.. ويبدو السؤال الآن: لماذا كتب عمار كتابه؟ ومن يجب أن يقرأه وماذا عليه أن يفعل.
(1)
في المقدمة يكشف المؤلف عما دفعه لإطلاق صيحته التحذيرية؛ ثم يتابع الدراسات التي حاولت فهم “المسألة المصرية” سواء دراسات الاحتلال/ الاستشراق، أو دراسات النظام الحاكم، ويخلص بعد عرض معوقات البحث الاجتماعي بمختلف أنواعه، إلى أن هناك نقصًا في دراسات تفاصيل حياة المصريين” تغيب إلى حد كبير الدراسات المتكاملة التي تنطوي على مسح شامل للمجتمع، دون أن تترك شاردة ولا واردة، إلا ونظرت إليها، وأعملت فيها طرائق العلم وأساليبه” وأننا نحتاج إلى هذه الدراسات: “لقد بتنا في حاجة ماسة إلى نظرة شاملة لمجتمعنا، تُشارك فيها عطاءات علوم عدة، وتُصاغ بلغة قابلة للتداول على نطاق واسع. ونحن بحاجة أيضًا إلى من يقومون بمهمة الوسيط بين الأكاديمي والمتلقي العادي باقتدار، وعن طيب خاطر، ليعرف أهل مصر المعاصرين ما آل إليه مجتمعهم الذي هبت عليه عواصف كثيرة، كنست في طريقها الكثير من الأفكار والتصرفات، وأتت في ركابها بالجديد، الذي لم يًرصد ويُدرس، إلى الآن، على نحو سليم” وأن كتابه محاولة في سد هذا النقص: ” هي محاولة لوصف مصر الآن، ربما تفيد من يروم إصلاحًا، أو على الأقل تفتح أفقا للنقاش حول حال مجتمع بات في خطر شديد”.
(2)
وفيما يشبه “السنة المصرية” يقدم عمار واحدًا وخمسين فصلاً، تنفذ ما حدد؛ عينات كافية وشاملة ودالة تعرض بلغة وسيطة، وبانضباط علمي. مع عنوان الفصل ستعرف ما باب الأذى الذي سيتحدث عنه، وفي نهر الفصل ستجد مسحًا شبه شامل عبر تقريب للعدسة مكانًا وزمانًا، واستدعاء للمشاهد المشابهة، مع تعليقات شارحة ومعللة.
في فصله المعنون “ضحك كالبكا” يحيلك المؤلف إلى بيت المتنبي الشهير:
” وَماذا بِمِصرَ مِنَ المُضحِكاتِ … وَلَكِنَّهُ ضَحِكٌ كَالبُكا
الذي تعامل معه خطيب الثورة العرابية حين أصدر: “التنكيت والتبكيت” فليس الضحك ترفًا، وإنما إياك أعني واسمعي يا جارة، ويبدأ بتسمية ثورة يناير المجيدة “الثورة الضاحكة” وعلاقة ذلك بطبيعة الشعب المعروف أنه ابن نكتة، لكن هل الضحك باب من أبواب الأذى؟ ولماذا؟ وعبر مسح لتاريخ الضحك السياسي المصري منذ المصريين القدماء يتوصل إلى أن سخرية المصريين كانت في أوقات كثيرة تنفيسًا عن غضبهم، وأن السلطة حين كان لها بعض العقل، جعلت من هذه السخرية استطلاعًا حقيقيًّا تقوم على إثره باتخاذ الإجراءات الناجزة، من توفير سلع وخفض أسعار وخوض حروب: ” ولعبت النكتة أحيانًا دور “الاستبيان” أو “استطلاع الرأي” لدى أهل الحكم أنفسهم، وبها عرفوا اتجاهات الرأي العام في وقت من الأوقات، واتخذوا قرارات بناء على ذلك. في هذا، يمكن أن نضرب مثلاً بنكتة دارت على الألسنة أيام حكم جمال عبد الناصر تقول: “سمع مواطن عن توفر السكر في الإسكندرية فركب سيارة أجرة إليها. عند بنها قال له السائق: تفضل انزل. سأله في اندهاش: إنها بنها. رد السائق: هنا آخر الطابور.” وقد وصلت النكتة هذه إلى سمع عبد الناصر، فعقد على الفور اجتماعًا للحكومة، لم ينته حتى تم تقديم حلول لهذه الأزمة” ويحدد عمار ان غياب الضحك باب من أبواب الأذى لأنه يعبر عن: “أن الهم والغم قد فاض واستحكم فوقع الناس جميعًا فى كآبة سوداء، أفقدتهم القدرة على التندر والضحك وإطلاق النكات، مردها انسداد الأفق السياسى، وتردى الأوضاع الاقتصادية، وانهيار القيم، واتساع التفسخ الاجتماعى، واحتضار الأمل فى غد أفضل لدى كثيرين” لكن هذه الكبت لن يؤدي إلا كما كتب في 2009 ” سبب اختفاء النكات هو أن مصر باتت مهيأة للحظة مخاض سيفعل فيها الناس ما هو أعلى وأهم وأكبر من التندر”. ويخلص إلى نتيجة: ” وهنا يثار السؤال: هل التنكيت معوق للحركة في سبيل التغيير؟
وأجيب على الفور: ليس بالضرورة، بل هو الذي يحيى قدرة الشعب على المقاومة، ولو بالحيلة، أو يمنعه من الرضوخ والإذعان الكاملين، أو يبقي جذوة الاعتراض مشتعلة، ولو كان لهبها خافتًا، أو يعطي الناس فرصة للاختلاف مع سياسات السلطة دون تحد سافر، يعرضهم للخطر”.
(3)
من الاعتداء على المكون الثقافي، إلى وجود عيب خِلقي في سمة من سمات المجتمع، وسنختار الفصل الموسوم بـ” السكون والحركة” الذي يناقش التغيير وسبله ومعوقاته التي يأتي على رأسها دوران الشعب المصري في دائرة مغلقة، نقطة البدء هي ذاتها نقطة الانتهاء، غاية الأمر تغيير الأسماء لكن المنهج المهيمن هو هو، ويرتكز في هذا الفصل على عدة محاور؛ التغيير غير المرئي، اختلاف رؤية الناس للتغيير بحسب ظروفهم، آلية التغيير وعوائقه، ثم نموذج منذ قرن يثبت أننا “محلك سر” يحدد سببين للتغيير: ” لا يحدث التغيير إلا بحركة هائلة، قد تكون ثورة جائحة، تتجدد معها الموجودات المادية، والمحسوسات المعنوية، وقد تكون مشروعاً وطنياً مختلفاً، تتبناه سلطة، أو يقوم على أكتاف نخبة فكرية وسياسية، تفرضه على أهل القرار” ثم ينفي حدوث هذين السببين فالثورة يتم الالتفاف حولها بثعالب مدربة، بعد انقضاض ضباع مجهزة على الأسود المتعبة، أما المشروع الوطني؛ فهو والعدم سواء، وما أسهل تكفير أصحابه، وتشويههم وتخوينهم: ” وتفتقد مصر إلى هذين السبيلين، فثوراتها سرعان ما يتم الالتفاف عليها من قوى مضادة لها، تفرغها من مضمونها، وتعيد ترتيب الأوراق والأحوال والتدابير لتمضي على حالها القديمة. والمشروع الوطني، بمعناه الشامل المتكامل الذي يكون حتى فوق الاستراتيجية العامة للدولة، غائب إلى حد بعيد”. لهذا فحين يعود لنموذج عشرينيات القرن المنصرم يجد أننا لم نتقدم خطوة بل تراجعنا كثيرًا، ولو عاد إلى عهد إسماعيل لوجد أننا كما نحن.
(4)
يعود المؤلف إلى النخبة في فصل مستقل ومتقدم “تفكيك النخبة” منطلقًا من مقولة (رب العائلة المصرية) حين قال: “”مشكلتي ليست مع العمال والفلاحين، إنما مع الأفندية” وفيم عارضته الأفندية؟ يجيب المؤلف: ” يقصد هنا فريقا من الجماعة الثقافية تصدر مشهد الامتعاض من أن يكون هو من يملأ الفراغ الذي تركه جمال عبد الناصر، ثم ضغط عليه بشدة ليحارب ويسترد سيناء المحتلة ومعها كرامة الجيش، ثم عادت تضغط من جديد حين قرر أن يبرم اتفاقية سلام مع إسرائيل، وبعدها استمرت تحذر من الآثار الضارة للانفتاح الاقتصادي الذي بدأ عام 1974، وترفع شعارات العدالة الاجتماعية في وجه رأسمالية محاسيب مشوهة راحت تتعزز باستمرار الوقت” وكيف وصل بنا الحال الآن؟ ” صرفت جزءا من طاقتها الغضبية الغاشمة، وسحبتها إلى نقابة المهندسين، لتبدد إرادتهم، وتبث رسائل إلى الجميع، بأن يدخلوا إلى “بيت الطاعة” الذي أقامته السلطة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي للمجتمع برمته، وأحاطته بأسوار صلبة سميكة، تريد أن تحشر داخلها عنوة كل من يرفع رأسه برأي أو موقف معارض أو مختلف”.
(5)
يضاف إلى أنماط أبواب الأذى ما يأتي من جهل المصلح، ومحاولته تحديث المجتمع على الطريقة الأوروبية، وكأن الأمر محض وجبة سريعة التحضير، وهذا ما تناقشه فصول عدة منها: “نساء منسيات” الذي يقارب ثلاث تجارب للتعامل مع المرأة المصرية دون إدراك لاحتياجات هذه المرأة، أو ما تقدمه بالفعل: ” إن جوانب ليست بالقليلة من انشغال الحركة النسائية في مصر، تغفل خصوصية مجتمعنا، ليس على مستوى منظومة القيم فحسب، بل الظروف الحياتية أو شروط الواقع القاسي أيضًا، وهو عيب لا بد من اجتنابه في قابل الأيام، ولا بد أيضا للمنظمات النسائية ان تنشغل بالأمور العملية ولا تكتفي بالتفكير والتنظير، إن كنا نريد حقاً أن ننهض بأوضاع النساء في مجتمعنا، لا سيما أن مصر باتت اليوم في حاجة ماسة إلى ذلك، أكثر من أي وقت مضى.”
(6)
من أبواب الأذى ما تقوم به السلطة للسيطرة الكاملة على مقاليد الأمور، ولو كان ذلك بترويض باب الخير ليصبح بابًا للأذى كما في باب “الخداع والإرغام” الذي يكون نطق فلاح “الاستنخاب” شرارة الانتباه إلى أن: ” تحولت “الانتخابات” التي كانت تحمل معنى “الاختيار”، وإمكانية التغيير الطوعي السلمي، إلى “استنخابات” حسب اللفظ الشعبي الدارج، على ألسنة الفلاحين في القرى، والمهمشين في الشوارع الخلفية للمدن. فأنماط الإجبار وأصنافه، هجمت قوية، دون استئذان أحد، لتفرض على الناس ما لم يرغبوا فيه، سواء من الشخصيات أو السياسات”. ولا يفلت المؤلف أعمدة الإجبار بل يفصلها؛ استبعاد كل من يسلك دربا مستقلا وحرا مخالفا للسلطة من خوض الانتخابات، وحزمة القوانين التي سنت فحرمت البعض من الترشح، واستعمال سلاح النفع في تمرير الأتباع، وإبعاد المعارضين. استعمال كل إمكانيات الدولة في خدمة السلطة السياسية.
(7)

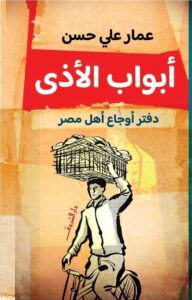
كلما أوغل القارئ في القراءة، أحاط بكثير من المشكلات التي تحاصر مجتمعنا، وتعرف أسبابها ومظاهرها وبقي له أن يتعرف حلولها بشكل جامع؛ وهو ما وجده متناثرًا لكنه يحتاج إليه مبلورًا، بعد أن بلورت المقدمة المشكلات في نقاط أساسية، وتلتها الفصول، ولن تخيب الخاتمة ظن القارئ؛ لأن الكاتب استند على منهج علمي قوامه؛ المكاشفة، وإعادة البناء؛ لهذا فكما علق الرس على رقبة الجميع، يحاور رجال السلطة وإعلاميها موضحًا أن المصريين لم يكفوا عن اقتراح الحلول العلمية والمنطقية والواقعية، وكل ما على المسؤولين أن يقرؤوا، وأن يؤمنوا بالديمقراطية الكاملة، وأن ينصتوا لمن هم خارج قصور السلطة لا على أنهم معارضة يجب قمعها أو تدجينها، بل على أنهم وطنيون متخصصون مخلصون، ويعلن في وضوح: ” إن مصر في غنى عن أي اضطراب، ولا يوجد عاقل يريد هذا لأسباب باتت معروفة أو في حكم “العلم العام”، لكن ما الذي يضمن ألا تنكسر معادلة الرهان على صبر الشعب، وتقع الواقعة؟ لماذا لا يعاد النظر في طريق الاستدانة وبيع الأصول والمشروعات الضخمة التي تستهدف قلة القلة؟ السؤال الأهم: لماذا لا يكون هناك إصلاح سياسي في قلبه رفع المظالم، وتخفيف الاحتقان؟ ولماذا لا تعتقد السلطة أن في مصر من يخلصون لمصلحتها، ولديهم وجهة نظر أخرى لهذا، وجب الإنصات إليها، بدلا من نبذهم أو تخوينهم؟”
…
بكلمة، كما حمل ريجان على عاتقه إصلاح مجتمعه بيده، فعلها عمار بقلمه، غير آبه بأسراب البوم التي تهاجم كل مخلص؛ لعجزها عن الإصلاح، ورفعها جلية لكل من يحب هذا الوطن؛ أفرادًا وجماعات، حكامًا ومحكومين، لا وقت للتخوين، ولا رغبة في التدمير، هذا وقت مصر.. فمن له؟ من لها؟
